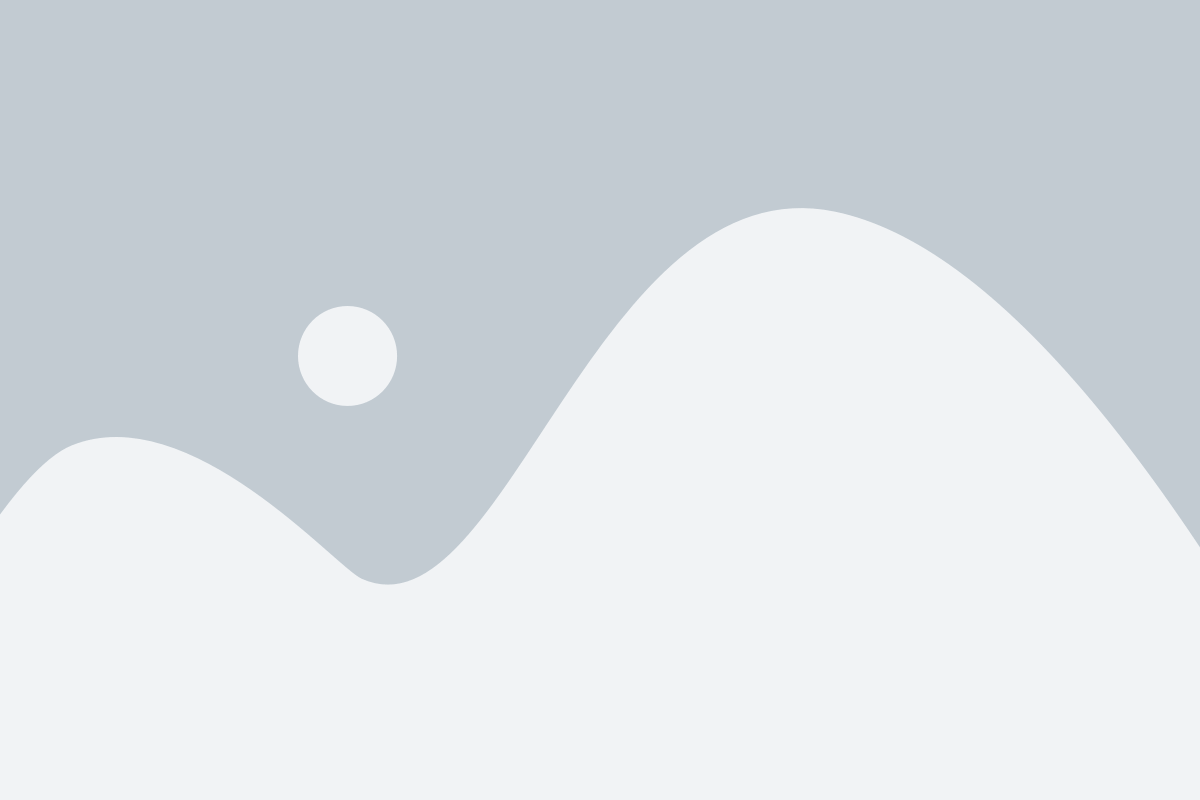قبل سنوات طويلة، لو سألني أحدهم: “ماذا تعرفين عن إيران؟”، لأجبت بذاكرة الطفولة: شادر مزهر، نساء رائعات، لغة كالمعزوفة، بلد بعيد محفوف بالحظر، ثم يأتي الزعفران، السجاد الشهير، الأغاني، وصوت شجريان. أما اليوم، لو سُئلت، لأجبت بعشرات القصائد من ديوان حافظ….
اليوم أعود إلى إيران في قراءة جديدة حيث نبدأ: في خريف عام ٢٠٠٠ تغيّرت حياة شيرين، حين كانت في تلك الأيام قد انتشرت في إيران عمليات اغتيال متعمّدة، بدأت منذ أواخر التسعينات، وقضت على حياة العشرات من المثقفين والفنانين، بيد أن الحكومة كانت متواطئة فيها. قرأت شيرين اسمها على “ لائحة الموت“، بأنها الهدف التالي. وفي غمرة صدمتها، أخذت تتساءل: «لماذا يكرهونني إلى هذا الحد؟ لماذا مصرّون على سفك دمي حتى إنهم لا يستطيعون انتظار نهاية شهر رمضان؟!» منذ ذلك اليوم، خرجت لنا شيرين لا تعرف معنى الخوف. المرأة التي ارتدت عباءة الشجاعة، وحملت شعلة العدالة لتضيء بها طريق المظلومين وتنصرهم.
بدأت مذكراتها من طفولتها، ومن صيفٍ كانت تقضيه بمتعة مع عائلتها في بيتهم الريفي في ضواحي همدان. في ذلك الصيف، تزامن سقوط رئيس الوزراء محمد مصدّق، فتصف ذلك اليوم بقولها: «أتذكر ذاك المساء بوضوح تام: عدنا إلى البيت وأصابعنا دبقة وثيابنا ملطخة بالتوت، لنجد البالغين في مزاج فظيع. بدا لوهلة أنهم أصيبوا بالجمود جراء الارتباك. جلسوا متلاصقين حول المذياع، أقرب إلى بعضهم البعض من المعتاد، وعلى وجوههم تعابير أشخاص مخمورين. وأعلن صوت مرتجف من المذياع، أطيح برئيس الوزراء محمد مصدق في انقلاب. لم يعن هذا الخبر شيئًا بالنسبة إلينا نحن الأطفال، فضحكنا ضحكات قصيرة متوترة أمام أعين الكبار المهمومة ووجوههم التعسة، وولينا الأدبار خارجين من غرفة المعيشة التي أصيبت بالجمود وتحولت إلى ما يشبه مكان العزاء». ومن بعدها، أصبحت إيران في عزاء طويل.
في عام ١۹٦٥، التحقت بكلية الحقوق، إذ ترى شيرين بأنها أهم نقطة تحول في حياتها، ووصفت حرم الجامعة في تلك الأيام بأنه مشحون بالاهتمامات الثقافية و يتورط يومًا بعد يوم في السياسات الساخنة التي ضربت إيران بأكملها، كانوا الطلاب بعد الظهر يخرجون في جماعات متظاهرين مدعين بأن الرسوم مرتفعة ليتجنبوا أعين السافاك المترصدة، في حين كان ما يتمنون الهتاف حوله هو أن يتوقف الشاه من الاستيلاء على عائدات النفط لأجل أمريكا، وأن يعود من منتجع الأثرياء في سويسرا، ويهتم لوضع الفقر في البلاد.
وتوالت أنانية و بذخ الشاه، حينما استعرض في عام ١٩٧١ ذلك الحفل الضخم لإحياء ذكرى مرور ألفين وخمسمئة سنة على نشوء الإمبراطورية الفارسية، الذي كلف المليارات من الدولارات من أجل خيام من حرير ومأدبة طعام فاخرة قادمة من فرنسا، في حين كان الشعب يعيش على خط الفقر. تقول: «كان مفرطاً في التأنق والزخرفة تماماً كالحفلة، ومفرطاً في غربته عن واقعنا، وعظمته سريعة الزوال ولا تدوم».
ثم توالت السنين و زال معها الشاه عام ١٩٧٩، وبدأ معها وميض الأمل للثورة التي اجتاحت إيران. كان الأمل حينها لا يقتصر على التغيير السياسي والاقتصادي، بل كان الحلم الأكبر هو نيل الحرية والكرامة والعدالة، وأن يتساوى الجميع. لكن سرعان ما تكتشف شيرين أنها، كغيرها، كانت مخدوعة، فتظهر لها السلطة الدينية بوجهها القاسي. السلطة التي تحوّلت إلى نظام قمعي، فأول ما فعلوه إعفاؤها من منصبها كقاضية، لتعمل لاحقًا كمحامية. وبدأوا قتل الحريات، وتضييق الأصوات، وتهميش المرأة وحقوقها، ذلك الأمر الذي كانت ترفضه وتقاومه، وظلت تسعى من أجله.
ولم تنتهِ الصراعات، حتى جاء عام ١٩٨٠، حين أعلن صدام حسين الحرب على إيران في شهر سبتمبر، وأطلق عليها «القادسية»، ليحاول فرض سيطرته على المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط. كانت حربًا استنزافية غير متعادلة. تقول شيرين إن صدام حينها كان يتمتع بالوصول إلى مخازن الغرب العسكرية، ويشتري الأسلحة الكيميائية من أوروبا وأمريكا، بينما بلادها – رغم كثافتها السكانية – لم تملك سوى فائض من حياة البشر، فأرسلوا الشبان في أعمار صغيرة للقتال ضد وحشية صدام وأسحلته الفتاكة. وانتهت تلك الحرب بعدما نزفت قلوب الأمهات، اللواتي ما زلن يبحثن عن جثامين أبنائهن الذين فقدنهم إلى الأبد.
تناولت شيرين في مذكراتها قضايا عدة، من بينها قضية جعلت قلبي يرتجف ويتألم لأيام: قضية الطفلة الكردية ليلى، البالغة من العمر أحد عشر عامًا. في صباح ما، كانت تجمع الزهور والنباتات البرية التي تقوم العائلة بتجفيفها وبيعها في السوق. لم تلاحظ وجود ثلاثة رجال بالقرب منها. رأى ابن عمها الصغير ما حدث، حين اختطفوها، واغتصبوها، ثم سحقوا رأسها، وقذفوا جسدها البريء في جرف عميق. إنها من أبشع القصص التي لا يمكن لإنسان أن يتخيّلها. وقد حاربت شيرين لأجلها، ولأجل ألف “ليلى” تُسحق بصمت، دون أن يشعر بها أحد أو يسمع حسيسها.
ثم تحدثنا عن حالة الهلع التي زرعها النظام بين الناس، حتى لم يعودوا يبوحون بمكنوناتهم لأحد، خوفًا من تلك الأيادي التي تخنق الناس وتغتالهم ليلًا. ذكرت في هذا السياق قصة اغتيال داريوش وبرفانه فوروهار، المثقفين المنشقين، في منزلهما في طهران، حيث طُعن جسدهما تكرارًا حتى فارقا الحياة. ثم عادت فرقة الموت لتغتال المترجم ماجد شريف، ثم لحقه الكاتب محمد مختاري، الذي وُجدت جثته مخنوقة في جنوب طهران، ثم الكاتب والمترجم محمد جعفر بويانده. انتشرت تلك الجرائم، وتوالت، وطالت عشرات الكتّاب والمثقفين والفنانين. وقد تولّت شيرين الدفاع في قضية مقتل داريوش وبرفانه فوروهار، في الوقت الذي أنشأ فيه الرئيس خاتمي لجنة تحقيق في هذه الجرائم المتسلسلة.
وفي صباح خريفي من عام ٢٠٠٣، عَبَرت شيرين عبادي نحو السلام. أُعلن اسمها كأول مسلمة، وأول إيرانية تفوز بجائزة نوبل للسلام. كانت لحظة فريدة، اجتمع فيها النضال والكرامة في جسد امرأة واحدة. المرأة التي قاومت الظلام بالكلمة، وواجهت الظلم بالقانون، ووقفت في أول الصفوف حين تراجع الكثيرون. شيرين التي مثّلت إيران الحقيقية، تلك التي آمن بها كل الإيرانيين، أصبحت في قلوب الأحرار، وحاضرة في دفاتر الطلبة، وفي صرخات الأمهات الثكالى. لم تكن الجائزة مجرّد وسام، بل صفعة للنظام الذي حاول تهميشها. ولم تكن وحدها أبدًا، كان خلفها التاريخ، وشعاع الأمل، وأنين المسجونين، وروح الشعب الإيراني الحاضرة دومًا. ليست أي جائزة، بل نور في قلب المعركة. وشيرين تضيء كل الدروب، لتخبرك: إن الحق لا يُهزم، وإن العدل، مهما تأخر، سيأتي يومًا وينتصر.
حين عادت إلى طهران، استقبلها الناس واصطفّت الجموع في بهو المطار والطرقات، يحملون الأزهار ويهتفون بعيون دامعة. كانت عودة نصر إلى شعب أنهكته سنوات القمع والانتظار. كان مطار مهرآباد ذلك اليوم أمام محفل من الفرح، لا أحد يستطيع قمعه. ردّد الناس الأغنية التي، كما وصفتها شيرين، تمتزج فيها المرارة بالفرح، الأغنية الشعبية التي رافقتهم كتعويذة سلام في كل ثوراتهم، وكأنها تحميهم رغم وجعها. أخذوا يهتفون بها من جديد بأمل: «يار دبستانی من». في حين كانت شيرين تكافح مشاعرها أكثر، عندما قرأت لافتة رفعتها امرأة، كُتب عليها: «هذه هي إيران».
أترككم مع يار دبستانی من، مع صوت الشعب الإيراني، وجراحه، وآماله وثوراته، ونضالاته…
يا رفيقَ دراستي،
يا من معي ومُؤنِسي،
كم هَوتِ العصا فوق رؤوسِنا،
وكنتَ عبرتِي وآهـاتِي.
قد نُقِشَ اسمي واسمُكَ
على هذا اللوحِ الأسود،
وما زال أثرُ سياطِ الجَورِ والظلمِ،
موسومًا على أجسادِنا.
بات سهلُ جَهلِنا
كل أعشابه ضارّة،
سواءٌ كان خيرًا أم شرًّا،
فقد ماتت أفئدةُ ناسِه.
يدايَ ويداكَ لابُدَّ أن تمزِّقا هذه الحُجُبَ،
فمن غيرُنا يُمكنهُ أن يُضمّدَ جِراحنا؟*
__________________________________________________
* لسماع الأغنية 《 يار دبستانى من 》بصوت: جشميد جم .